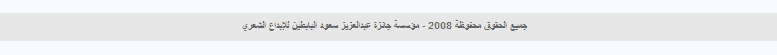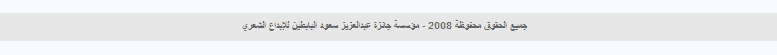|
عززت نتاجات الشعراء الرواد موقف الشعر والشعراء في البلاد بالرغم من أن القليل جداً من هذه النتاجات هو الذي وجد طريقه إلى الظهور في دواوين مطبوعة. وحتى أواخر الأربعينيات لم يكن قد ظهر من دواوين الشعر المطبوعة سوى عدد قليل لا يتجاوز عند الحصر الدقيق عدد أصابع اليدين, ومعظم هذه الدواوين إن لم تكن كلها للشعراء الذين يسكنون في عدن المحتلة, ولعل أول ديوان مطبوع ظهر لشاعر من شمال الوطن كان (النفس الأول ـ للشاعر محمد الشامي) في العام1956 م.
وهذه الإشارة على عفويتها ذات دلالة بالغة الأهمية فهي تثبت أن الشعر قد ظل مادة شفهية, يتناقله الرواة والحفاظ, وتحتفي به مجالس (القات) وميادين المناسبات.. وليس جديداً القول أن الفن عموماً والشعر منه بخاصة ينطلق من الحرية بأوسع الحدود والأبعاد وتمكنه المطابع من الذيوع والانتشار.. ولأن الأمر كذلك فقد كان من الصعب, والحالة كما كانت عليه, في اليمن طوال النصف الأول من هذا القرن, أن يستقيم حال الشعر أو حال أي شكل من أشكال الإبداع.
وفي غياب الحد الأدنى من حرية التفكير والكتابة وفي غياب الحد الأدنى أيضاً من وسائل النشر فقد كان على المبدعين أن يتحايلوا لكي يصلوا إلى الناس ويعملوا جادين وجاهدين على إخراج الكلمة من سجنها المرعب... وقد اهتدى الرعيل الأول من الرواد في بداية انطلاقتهم إلى الكيفية التي تجعل الشعر يعلن عن نفسه ولو من خلال المدائح التي تقال في الحكام والتي كانت تعتمد على ذكاء الشاعر ومهارته في إبراز صورة الشعب إلى جانب الحكام وصورة الشعر إلى جانب الاثنين كما فعل الشاعر (محمد محمود الزبيري) الذي حاول في بداياته الشعرية أن يصهر الحاكم والشعب والشعر في تركيبة واحدة هي القصيدة, فهو يمتدح الحاكم لأنه سيعمل على تغيير واقع الشعب حريصاً على تطوره وتحديثه, ويدعوالشعب إلى أن ينهض من سباته الطويل, وهو يحاول أن يجعل للشعر صوتاً مسموعاً لدى جماهير الشعب. وقد اكتشف الشاعر الشهيد ـ ومنذ وقت مبكر ـ أن محاولته تلك محكوم عليها بالفشل, وإن كانت قد كسبت للشعر أنصاراً ومريدين وفضحت ـ في الوقت ذاته ـ تحجر الحكام وإصرارهم على استنزاف طاقات الوطن وعرقلة مسيرة أبنائه.
وفي شهادته الشخصية عن هذه المرحلة وعن تلك المحاولات الشعرية الفاشلة (وهي الشهادة التي لم يفهمها بعض الشعراء والكتاب في بلادنا ولم يتوصلوا إلى قراءتها قراءة صحيحة) في هذه الشهادة ما يسترعي الانتباه ويكشف عن الجهد المضني الذي بذله الشهيد الزبيري وزملاؤه من الشعراء الرواد في سبيل تجديد الوطن والشعر معاً:
(إن محاولة إقناع الإمام يحيى بواسطة الفكر الديني ثم المدائح الشعرية التي قدمت إليه في هذه المرحلة التجريبية كلها تعتبر وثائق تأريخية, تدل على المحاولات الجادة لإقناع الإمام بالحكمة وبأرق الوسائل الودية كي يسمح بالتطور الإصلاحي المنشود, ولا يستطيع أحد في المستقبل القريب أو البعيد أن يزعم بأن الإمام يحيى عارض الإصلاح خوفاً على الدين فإن التجربة قدمت نفسها كدين, أو يزعم بأنه تشدد واستبد, وأصر على طغيانه لأنه صدم شخصياً, أو جرح كبرياؤه, فالشعر شاهد حي سيبقى برهاناً تأريخياً على أن الإمام يحيى ـ الذي لقي مصرعه بعد سنوات قليلة من المدائح والاستعطاف ـ كان قد أُعطي أكثر مما يستحق من الثناء والاحترام, وأتيحت له الفرصة, ووفرت له الكرامة وقدمت إليه الأفكار والنصائح في جو من الود والإكبار, لا يدع له مجالاً للتعلل والاعتذار, وإنه باصراره, ـ رغم كل ذلك وعناده ـ واستبداده, يعتبر المسؤول الذي جعل الخلاص منه بالقوة هو الطريق الوحيد الذي لا سواه.. أنا أعرف أن الذين يعيشون في ثورة اليوم, ووعي اليوم من شباب اليمن بالذات يضيقون من محاولاتنا لتبرير الثورة على الأمام يحيى, فهي قد أصبحت من البديهيات ولكن إذا كانت الأمور بعد عشرين عاماً تبدو لنا واضحة جلية, ويبدو فيها وجه الحق بيناً ساطعاً. فهي لم تكن كذلك من قبل... كان كل ما في اليمن يبدو مشوشاً غامضاً مظلماً, بل كان عالماً من الألغاز, والطلاسم والمتاهات)(11).
ومن منظور اللحظة الراهنة فإن الشهيد الزبيري لم يكن بحاجة إلى كل هذا القدر من التبرير والندم على الكلمات التي ذهبت أدراج الرياح في مدح طاغية لم يتغير, ويكفي أن تلك المدائح قد جعلت الشعر ـ بعد أن توصل الشاعر إلى اليقين الثوري ـ يكتشف معناه الأوسع وعالمه الخاص, وأن الكلمات في عهدها الجديد قد حاولت ـ وربما نجحت ـ في أن تضع أجنحة للشعر يطير به بعيداً عن عتمة الماضي وغيبوبته, ولو بعد حين, فقد آثر الرعيل الثاني من الشعراء اليمنيين أن يسير على خطى الروّاد, وظهر الشعر في الخمسينيات وكأنه يستعيد قليلا قليلا ما كان له من تأثير مركب, وبدأ الشعب الجاهل الأمي يسترق السمع إلى القصائد من خلال الإذاعة ومن خلال الاحتفالات التي كانت تقام في المناسبات الدينية والرسمية كاحتفالات (المولد النبوي الشريف) واحتفالات (عيد نصر الإمام) وكان الشعراء يتعمدون قراءة قصائدهم في هذه المناسبات حتى لو كانت مدحاً في العرش وتمجيداً للطاغية. وفي هذا المناخ لمعت أسماء كثيرة من بينها أسماء أربعة شعراء كانت قصائدهم المناسباتية تفعل في المستمعين (الأميين) فعل السحر, ولم يكن هؤلاء الأميون ليتوقفوا عند الأبيات أو المقاطع المدحية التي تصف شجاعة الإمام وكرمه وقدرته على التنكيل بخصومه, وإنما كانوا يتوقفون طويلاً عند تلك المقاطع التي تتحدث فيها القصائد عن الواقع البائس الذي يعاني منه الناس في البلاد, عن واقع التشطير والحرمان من إشعاع العصر الحديث.
والشعراء الأربعة هم: (محمد سعيد جرادة) (عبدالله البردوني) (علي بن علي صبره) (عبدالرحمن الأمير) ولن تكون الدراسة محابية أو مجافية للحقيقة إذا ذهبت إلى القول بأن هؤلاء الأربعة هم أبرز شعراء الخمسينيات داخل الشطر الشمالي من البلاد وأجهرهم صوتاً وأكثرهم شهرة على تفاوت في درجات هذه الشهرة فيما بينهم. ومهما اختلفنا حول قصيدة المدح المعاصرة ومهما تباينت وجهات النظر حول الدور المتخلف الذي تؤديه فإن أحداً لا ينبغي أن يغيب عنه وضع اليمن في ظروف كتابه تلك القصائد المدحية, كما لا ينبغي أن نغفل الدور الذي لعبة هذا النوع من الشعر في تأكيد أهمية الشعر, وفي إبراز الشعراء وتأهبهم للقيام بدور فاعل ومؤثر في الحركة الوطنية التي كانت قضيتها قد ولدت في ثنايا القصيدة المدحية على حد التعبير المركّز التالي للشهيد الزبيري (إن القضية ولدت هناك في تعز في صورة قصائد طنانه. كنا نلقيها على الجماهير في محافل الأعياد الضخمة لولي العهد, لقد كان عملنا يومئذ يعتبر تقدمية ونهضه. وجرأة على تطوير الأساليب القديمة في الأدب والشعر وجرأة على الظهور والطموح والتبشير بوجود عصر حديث لم يكن للناس في بلادنا علم به وقد فطن ولي العهد أحمد إلى هذا المغزى العميق لحركتنا. هناك كنا ندرك أننا نهز طموح هذا الرجل ساعات من الوقت . ولكنه عندما يعود إلى عنصره المستبد, ورواسب طغيانه, كان يجزع ويتألم لأن الجماهير عرفتنا ولأن الأدباء قدموا إلينا التهاني شعراً ونثراً وأظهروا إعجابهم بملامح الأدب الحديث).
ولو وجد بقية الشعراء الأحياء فسحة من الوقت ليقولوا شهادتهم عن تلك المرحلة وتلك القصائد لما اختلفت عن هذه الشهادة التي أحاطت بالمناخ الثقافي والسياسي والنفسي والاجتماعي الذي تم فيه انتاج ذلك الأثر الشعري الذي ما يزال موضع حديث الأوساط الأدبية والنقدية . ودفعاً لكل لبس قد يحدث تجدر الإشارة إلى أن الشعر المدحي لم يكن سوى خيط رفيع في نسيج القصائد الأخرى التي تناولت الطبيعة وغنت للوطن والحرية والاستقلال وكانت التعبير الصادق عن الحنين الروحي إلى معانقة العصر والخروج من أزمنة التقليد والاجترار.
وقبل أن نستعين بالنماذج الشعرية التي توسل الشعراء الأربعة بالمديح للوصول إليها وإلى تثبيتها في وعي الناس وضمائرهم, واستكمالاً لصورة الشعر في هذه المرحلة من التأريخ اليمني القريب لا بد من القول بأنه كان على الجيل الثاني من الشعراء في اليمن ـ اعترافاً بقسوة الظروف ـ أن يدخلوا في نفس التجربة التي خاضها الجيل السابق أو أن هذا الجيل قد احتاج إلى زمن أطول لكي يصل إلى نفس النتيجة المريرة التي عبرت عنها كلمات الأستاذ الزبيري في المقتبسين السابقين قبل أن يسلمه اليأس وخيبة الأمل إلى مرحلة التمرد والانفجار تلك المرحلة التي اختفت معها كل الأوهام القديمة في محاولة تغيير الحاكمين عن طريق استدرار عطفهم على الشعب ووصفهم الرقيق الحزين لما يعاني منه من بشاعة الظلم والاستبداد والبعد عن مصادر النور والمعرفة.
ومما لا شك فيه أن المضمون السلبي الذي ينطوي عليه هذا النوع من الشعر المادح لا يعجب أحداً الآن كما لم يكن يعجب أحداً بالأمس سوى الحكام أنفسهم إلاّ أن دوره ـ أي شعر المديح ـ في فضح مخازي الواقع الذي كان قائما يضعه ضمن الوثائق السياسية التي تدين أنظمة القمع في محاولاتها انتزاع الثناء من المبدعين بالترهيب والترغيب وذلك ما تذهب إليه هذه الفقرة من اعتذاريات الشهيد الزبيري ( وأنا أذكر أن قصيدتي في استعطاف الإمام والشكوى من أهوال السجن انتشرت في صفوف الشعب انتشاراً سريعاً قبل أن تصل النسخة المرسلة إلى الإمام وأنها أحدثت أثراً عاطفياً في صالح الأحرار المعتقلين, وحسنت نظرة الشعب إليهم وهيأت الشعب لنقد تصرفات الإمام, ورغم أنه كان فيها استعطاف ومدح للإمام يحيى فقد كانت تنطوي على وصف لآلام السجن قصدت به تسجيل هذه الحقيقة تأريخياً في صورة ضراعة واسترحام, على قدر ما كانت تلهمنا الظروف يومئذ).
|
|