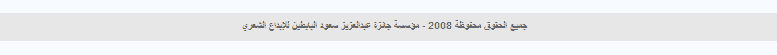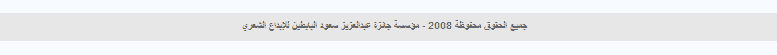|
(5)
والآن... أين تقف بنا القصيدة المعاصرة, أو قصيدة (ما بعد الحداثة) كما يحلو لبعض النقاد والدارسين أن يصفها؟.
لعل أوضح ما يسم هذه القصيدة هو النزوع إلى التجريب الدائم والمغامرة الفنية المستمرة, فهي ـ من هذه الوجهة ـ قصيدة لا تقنع بذلك الاطمئنان اليقيني وتلك النبرة (الراضية) التي كانت تميز رواد الشعر الجديد, وهي ـ بدلاً من ذلك ـ ترفع شعار البحث الدءوب عن صيغ شعرية أكثر غنى وأكثر عمقاً, وغناها وعمقها لا ينحصر في مجرد السعي وراء ما لم يُقل كما كان يسعى جيل الرواد, بل وإلى قول ما لم يقل بطريقة لم يُقل بها آنفاً, ومن ثم يصبح العمل الشعري بوتقة ينصهر فيها النص بالموقف, وتتوالج من خلالها اللغة ودلالات اللغة, بكل ما يعنيه ذلك من تكامل القصيدة الحديثة على مختلف أصعدتها البنائية.
فالعمل الشعري ـ من ثمة ـ تجاوز للثابت, وتخطّ للمستقر, واستكناه لما لم تؤطّره بعد الأعراف الشعرية والمواضعات النقدية المستقرة, وهو فضاء إبداعي لا يملؤه سوى مبدعه, ولايستمد منطقه إلاّ من داخله, ومن هنا فهو خطوة غير مسبوقة, والمرحلة التي ينتمى إليها لا تكرر سابقتها, قد تأخذ منها ولكنها ـ بالأساس ـ ترفضها, وسرعان ما يتحول الرافض ـ بدوره ـ إلى مرفوض, ولهذا كثرت المراحل وتوالدت الأجيال الفنية في حقبة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات على نحو لم يعد فيه للركود وجود, وأكثر ما يتجلى هذا تجلياته بخاصة عند طالعة الشعراء في مصر ولبنان والعراق والمغرب, وهي المواطن التي تكاد فورة التجريب فيها تأخذ بعداً يومياً متجدداً, وليس محض مصادفة أن التكتلات الحداثية التي تزيَّتْ في مصر بشعارات (إضاءة) و(أصوات) وما إليهما كانت لها نظائر في العراق فيما دعي بالشعراء (الستينيين) الذين لم تكن لتكرثهم كثيراً مجرد المؤرقات العروضية أو الهموم الشكلية, بل كانوا تجسيداً لرؤية جمالية وإبداعية تجاه العصر والتراث تصادم كل ما كان قد استراح إليه رعيل الحداثة الأول من مسلمات التجديد في الدلالات الفكرية والاجتماعية والسياسية للعمل الشعري, وعلى نفس الدرب, وفي نفس الظروف الزمنية تقريباً, كان شعراء الطليعة في البيئة المغاربية, وفي تونس بالذات, حيث راحوا في بياناتهم النظرية يعبرون عن اقتناعهم بأن الإطار الخليلي قداستنفد أغراضه, وأن الهدف الآن يتمثل في إبداع القصيدة المضادة التي لا تكتسب موسيقاها من نمط إيقاعي سابق, بل تستمد إيقاعها من داخلها, وإذا كان لها من متكأ خارجي فهو إيقاع العصر الذي تتنفس فيه.
وإذا كانت فورة التجريب تتواصل ـ هكذا ـ عبر بيئات إبداعية متباعدة المسافة, مما يضفي عليها ثوب الشمول, وينفي عنها طابع النزوات الفنية, فإنها ـ باعتبار فني ـ قد تناولت مختلف الأصعدة البنائية, فعلى الصعيد الإيقاعي نرى القصيدة لم تكد تستقر على وحدة الجملة الشعرية بديلاً للسطر الشعري, حتى راحت تنتقل من وحدة الجملة الشعرية إلى وحدة الفقرة أو المقطع الشعري , ولم تقنع بذلك حتى راحت تضيف إليه استغلالا دءوباً لكل إيحاءات الحس الصوتي والأطروحات البديعية كالتقابل والتجانس والتكرار والازدواج, تلك الأصباغ التي كانت تعالج في البلاغة الشعرية التقليدية بآلية بالغة , ولكنها غدت تحظى في القصيدة المعاصرة بمغزى جمالي جديد.
وعلى صعيد المعمار الشعري ذاعت تقنية تعتمد على تقاطع الأصوات في القصيدة الواحدة, سعياً وراء اقتناص اللمع والشوارد المتزامنة, وبغية تقديم كل ما يتفاعل في اللحظة الإبداعية من أحاسيس وأفكار متواكبة, مما لم يكن الشكل التقليدي يسمح بطرحه دفعة واحدة, وقد كان الشاعر أمل دنقل من أكثر الشعراء توظيفاً لهذه التقنية التي كانت, فوق عملها على اصطياد كل تفاعلات اللحظة الشعرية, تضفي على القصيدة حركة درامية دافقة, ومن الإنصاف أن يقال إن ظاهرة تعدد الأصوات قد استغلت بمهارة في بعض أعمال صلاح عبدالصبور من قبل, وأن ظاهرة القطع والاعتراض قد سبق استخدامها في غير قليل من قصائد السياب والبياتي والحيدري, ولكن الجديد في شعر السبعينيات وما بعدها أن المبدعين قد قطعوا الشوط, ربما, إلى نهايته, فقدموا في إطار القصيدة الواحدة أكثر من صوت, كل صوت بمسار مستقل , وكل صوت يوازي الآخر أو يحاذيه , ويتراسل معه أو يتقاطع, فكأننا من القصيدة الواحدة أمام قصائد عدة, تطرح متواكبة لا متعاقبة.
وعلى الصعيد التركيبي تنتظم القصيدة الحديثة ـ أو ما بعد الحديثة إن شئت ـ وفق أجرومية شعرية تعتمد على هزّ العلاقات بين الدال والمدلول, وإناطة هذه العلاقات بالنص بدلاً من إناطتها بالذاكرة التراثية, هذا بالإضافة إلى الحفاوة البالغة بما كان يسميه (جاكوبسون) (أعصاب النص الشعري) ممثلة في الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات وماشابهها من ركائز الخطاب الشعري, وقد كانت هذه النظرة أساساً بنى عليه شعراء الموجة الجديدة محاولاتهم في تصفية الصورة الشعرية وهزّ إطارها اللغوي, وردّ الكلمة بالمزج والتركيب إلى كيانها العفوي الأول, الذي فقدته بكثرة الاستعمال, والإفادة من الإيحاء التلقائي في الألفاظ والتراكيب غير المطروقة, بغية الانفلات من أسر تلك القوالب التعبيرية التي ركّت مفاداتها على مدار الأيام.
على أن تخطّي القوالب التركيبية المألوفة لم تكن غايته الترفع عن الابتذال وحسب, بل كان ـ في أهم جوانبه ـ رغبة في جعل السياق اللغوي صورة من إحساسات الشاعر وأفكاره, وفي تلك الحالة قد يقدم الشاعر عنصراً من عناصر الجملة الشعرية لم يعهد تقديمه, لأنه أسبق وروداً في مجرى الشعور, وقد يفصل بين متلازمين لا يقر منطق الفكر الواضح الفصل بينهما; لأن حركة النفس من التعقيد والاضطراب بحيث لا تطابق حركة الأنماط اللغوية مطابقة ضرورية, وفي هذه الحالة ربّما بدا ـ على مستوى التعبير ـ أن الفاصل عارض يمكن التنازل عنه, ولكنه على مستوى الحركة النفسية يمثل خطاً شعوريا موازيا للخط المحوري في العمل الشعري.
ويتصل بهذا موقف آخر للمحدثين إزاء ركاكة التعابير الوصفية التي استهلكها الاستعمال أو كاد, وقد حاولوا التغلب على هذه الركاكة باستمداد الأوصاف من مجالات غير مجالات الموصوفات, وقرن البعيد بالبعيد, وتبادل الموصوف والوصف وضعيهما تأخيرا وتقديما, وإضافة ثانيهما إلى أولهما بعد تقديمه عليه, مع ما يتركه ذلك في نفس المتلقي من إدهاش مبعثه ورود التركيب بصورة لم يكن يتوقعها, فتكون المفارقة بين المتوقع واللامتوقع تفجيراً لكل كوامن المفاجآت والإغراب.
ومن أبرز آثار الأجرومية الشعرية الجديدة تصفية أسلوب التشبيه بحذف فواصله بغية توحيد المشبه بالمشبه به, فمن المعلوم أن التشبيه في الأصل معادلة بين طرفين تقوم على المقابلة والاستنتاج, وأدواته في جملتها أدوات وعي ووضوح وتقدير , وهي تقرب بين الطرفين لكنها لا توحد بينهما, ولا تتيح للشاعر ذلك الاستغراق العميق بالأشياء, حيث يتجاوز القياس العقلي إلى الحدس النفسي, ثم إلى الرؤيا التي تقبض على وحدة الموجودات في عالم الشعور البكر قبل أن تتوزع وتتفرق إلى أمشاج, ومن أجل هذا أهمل كثير من المحدثين تلك الفواصل التشبيهية, ورأوا فيها أدوات فكر واستدلال, إن صلحت للتعبير عن العالم الخارجي , عالم المنطق والعقل والعلم, فإنها قاصرة عن تلك الرؤى النفسية التي تحيا في عالم الذات, حيث تنمحي الحدود بين الروح والمادة , والداخل والخارج.
إلى هنا ويبدو واضحاً أن تجديد الحداثيين على مستوى الأجرومية الشعرية ظل في كثير من جوانبه داخل الإطار العام لما تبيحه اللغة, كما أنه يدخل ـ بقدر من التسامح ـ في نطاق (المباحات) التكوينية للقصيدة , وتلك غاية كل تجديد مفيد: أن يطور اللغة بقدر ما يستلهم روحها, وأن يبرز من طاقاتها التعبيرية ما كان كامناً, وما يبدو لأول وهلة غريباً , وما هو بغريب , ولكنه جار على غير الشائع والمطروق. غير أن هذه الحقيقة لا تضيء سوى جانب واحد من جانبي القضية, لأن شأن المحاولات التجديدية أن تلتبس ببعض أوجه الشطط, وقد يفضي بها هذا إلى مزالق لم تكن لتفضي إليها لو وجدت عوناً من جمهرة النقاد والدارسين, ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن واقعية التجريب ما لبثت أن حدت ببعض المعاصرين, إلى اقتحام نطاق (المحظورات) على اعتبار أن لكل قصيدة (نحويتها) الخاصة, ومن هنا شاع في القصيدة الحديثة ما يسمى (صدع النظام), فعاد الضمير أحيانا على متأخر لفظا ورتبة بغية خلق جو من الغموض اللفظي, ودخلت (أل) أحياناً أخرى على ما لا يصح دخولها عليه من الأفعال, وتشظّت الجملة اللغوية, بل والكلمة الواحدة, فانتثرت عبر سطور شعرية عدة, ليوحي هذا وأمثاله بفاعلية (التفجير) التي يتذرع بها الشاعر المعاصر تجاه لغة القصيدة.
إن ثمة حسّا لغوياً يكتسب من مخالطة التراث القومي وتمثله, وهذا الحس هو أداة الشاعر في تطوير لغته , ولكنه في الوقت نفسه سلطة غير منظورة توجهه بما لا يخرج عن روح اللغة, وأهون أنماط التجديد ما يخدش ذوق اللغة دون غاية فنية, لأنه في تلك الحالة يخون الحس اللغوي والشعري معا.
لقد انصرم على تجربة (الجديد) في شعرنا المعاصر قرابة نصف قرن, وربما لم تكن محاذير هذه المرحلة مؤثرة بحيث تدفعنا إلى الجزع أو الجهامة ونحن نستشف منظور المستقبل بالنسبة للقصيدة الحديثة, بيد أن هذا المنظور ـ فيما نخال ـ وثيق الارتباط بماضي التجربة على قصره, ولا مناص من التصدي للمزالق الناجمة إذا أريد إثراء هذه التجربة وتسديد مسارها, وإذا كان المقام قد اتسع للإشارة إلى بعض وجوه الإسراف في التعامل مع التركيب الشعري, فقد يسمح بإشارة مماثلة , وإن تكن أكثر إيجازاً, إلى بعض الملاحظ على المستوى الإيقاعي, ومن أبرز هذه الملاحظ ما يتعلق بظاهرة (التدوير) التي غدت تستأثر برقعة فسيحة في المساحة الشعرية, وقد كان قصارى ما ندين به تلك الظاهرة أنها تطفيء الإيقاع وتجهد المتلقي في اللهاث وراء الشاعر حتى ينتهي إلى قرار بيت يمكن التوقف عنده, ومع ذلك قد كان هذا الجهد محتملاً في ظل ضيق الظاهرة ومحدودية نطاقها الشعري, ولكن ماذا يقال الآن وقد امتدت أصابع التدوير فأضحت تستغرق ـ أحياناً ـ رقعة القصيدة بأكملها, وحتى غدت وحدة المقطوعة, أو وحدة العمل برمته, تحل محل السطر الشعري؟!.
وظاهرة أخرى هي نمطية الأوزان المستخدمة وقلة تنوعها, فمن المعلوم أن قلة قليلة من نماذج الشكل الجديد هي التي كتبت, أو تكتب, في إطار الأوزان المركبة, وأن كثرته الكاثرة تدور في إطار الأوزان السبعة البسيطة: الرجز والمتقارب والمتدارك والكامل والرمل والوافر والهزج, وحتى هذه الأوزان السبعة ليست سواء من حيث نسبة دورانها على أقلام المبدعين, لأن جمهرة الشعراء تركن إلى الإمكانات الإيقاعية في الأبحر الأربعة الأولى, وتكاد تحرم نفسها ما عسى أن تقدمه الأوزان الأخرى من عطاء إيقاعي, لدرجة أن بعض المجموعات الشعرية الكاملة توشك أن تكون تنويعات نمطية على وتر وزني واحد لاتتجاوزه, رغم اختلاف التجارب وتنوع الرؤى الشعرية!!.
وأخشى ما نخشاه أن تفضي نمطية الإيقاع ـ بالدوران داخل أوزان بعينها ـ إلى نمطية التصوير والتعبير, وقد بدأت تلوح نذر ذلك بالفعل, لأن الإيقاع ليس كياناً موسيقياً أصم, بل هو قادر على أن يستدعي إلى ذهن المبدع جملة الرموز والصيغ التي ارتبطت به بحكم التكرار والمعاودة, ومن ثم لا يكون الشاعر الجديد قد نجا من تقليد للقديم مستهجن, إلا ليقع في قبضة تقليد للحديث أكثر هجنة, ولا عاصم من ذلك إلا بخصوصية الشاعر في التهدّي إلى أكثر الإيقاعات مواءمة لتجربته, وأصالته في ارتياد المذخور منها, بكل ما تتيحه من إمكانات التنوع والإضافة.
وحتــى فــي هذه الحالة الأخيـــرة لا نعدم شاهداً لما افتتحــنا به هذه التوطئة من توكيد الماهية المشتركة للشعــر العربي الحــديث, وتناغم السمــات الفنية التي اتســـم بها, والمراحل والأطوار التي تنقل عبرها, دون إلغاء أو إنكار لما تتمتع به البيئات الإبداعية, أو لما يتميز به أفراد الشعراء وأجيالهم, من خصوصيه في التجلّي, أو تمايز في الرؤى الجمالية والهموم الفكرية.... ولعل من أبرز آيات هذه الماهية المشتركة في الأصول والأطوار ما نلحظه من تواكب الأطر الإبداعية في بيئات الشعر العربي على اختلافها دون أن ينفي أحدها الآخر أو يلغيه, فعلى الرغم من الاندياح الواضح لإطار التفعيلة ثم لقصيدة النثر, نجد عديدًا من الأصوات المدوية العاكفة على الديباجة العمودية في محاولة للمزاوجة بينها وبين هموم العصر, وهي أصوات تمتد بامتداد التربة الشعرية, ولكنها تتفاوت في كثافتها وعمقها بتفاوت أنصبة الأقطار العربية من الثقافة التراثية في ناحية, والثقافات الأجنبية في ناحية أخرى, فإذا كانت بيئة كبيئة الشعر العربي في لبنان والمغرب أكثر اتكاءً على التجريب وتحكيم حس المغامرة الإبداعية, فإن بيئة كبيئة الشعر العربي في موريتانيا أكثر اتكاء على نموذج الأصولية العمودية التي تستلهم تراث الشعر العربي القديم في أخيلته ورؤاه وأوزانه وأصباغة الفنية بعامة, الأمر الذي يقطع بأن ساحة الشعر العربي لم تفقد خاصّية التكامل بين القديم والحديث حتى وهي تعاني آلام المخاض الفني, وقد حاول معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين أن يرصد ملامح هذا التكامل ودرجاته ومراحله بقدر ما وسعه الجهد وأمْكنته الطاقة, وهو - من ثمة - لا يعرّف بالشعراء فحسب, ولا يسجّـل نماذجهم فقط, بل يضيف إلى هذا وذاك تقديم مادة علمية سيتناولها الدارسون - من بعد - بالتصنيف والدرس والتحليل, وعلى الله قصد السبيل.
أ. د. محمد فتوح أحمد
|
|